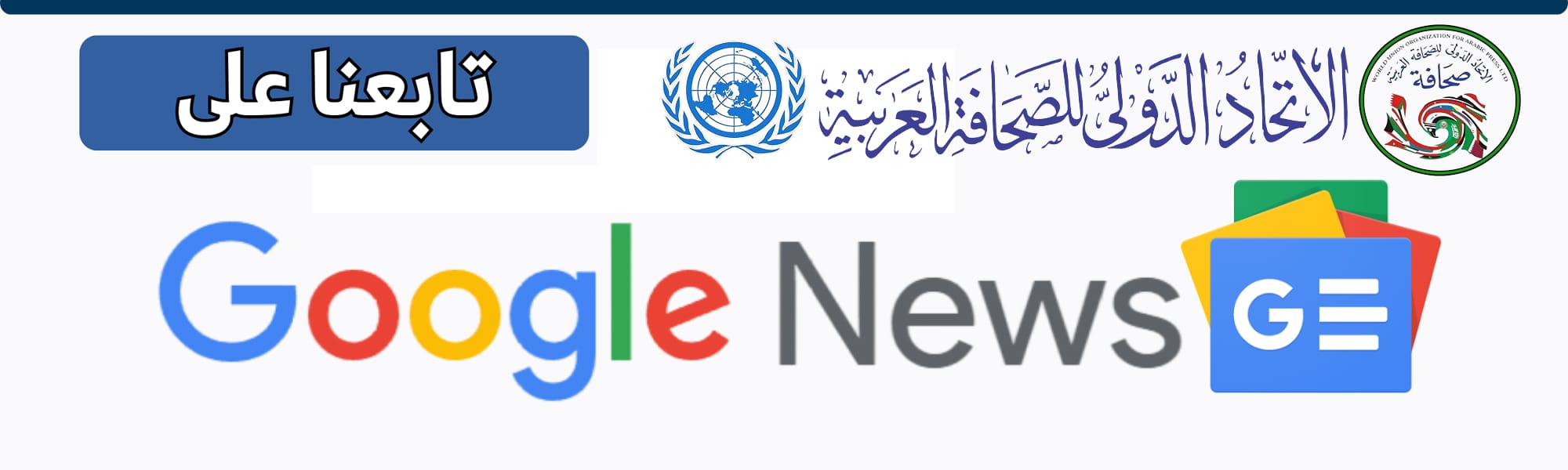سنترال رمسيس من الملك فؤاد إلى الاحتراق

في صباح مشمس من يوم الأربعاء، الخامس والعشرين من مايو عام 1927، كانت القاهرة على موعد مع حدث تاريخي غير مسبوق. في شارع الملكة نازلي، حيث يقف اليوم سنترال رمسيس شامخًا، تجمّع الناس في ساحة الاحتفال ليشهدوا افتتاح دار التليفونات الجديدة على يد الملك فؤاد الأول. وسط الحشد، أمسك الملك بسماعة هاتف فضية صنعت خصيصًا في مدينة ستوكهولم السويدية، وتحمل نقشًا يخلد المناسبة: “الجهاز الذي تفضّل به فؤاد الأول ملك مصر وافتتح به سنترال تليفون المدينة بالقاهرة”. أجرى الملك أول مكالمة هاتفية عبر الجهاز، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ مصر يُفتح فيها باب التكنولوجيا والاتصال على مصراعيه.

منذ ذلك اليوم، لم يكن سنترال رمسيس مجرد مبنى إداري أو مرفق خدمي، بل كان رمزًا للتقدم، قلبًا نابضًا للبنية التحتية الرقمية، يربط مصر ببعضها وبالعالم. وعلى مدى عقود، ظل هذا السنترال يُمثل نقطة الارتكاز الرئيسية لشبكات الاتصالات والإنترنت، ويمتد تأثيره إلى الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية والمرافق الحيوية. أصبحت كبرى الشركات مثل فودافون وأورانج تعتمد عليه في توجيه المكالمات وربط الشبكات محليًا ودوليًا.
مرّت السنوات، وتحولت البنية التحتية في مصر إلى كيان رقمي متكامل يعتمد على سنترالات رئيسية، كان أبرزها سنترال رمسيس. وفي إحدى الشهادات المنسوبة إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، كشف أن الولايات المتحدة حاولت في التسعينيات تنفيذ خطة لربط جميع السنترالات المصرية بسنترال رمسيس، بهدف تركيز نقاط التحكم وتسهيل السيطرة أو التعطيل، وهو ما بدأ بالفعل في الجيزة. لكن مبارك، وفق ما قاله، تلقى تحذيرات من القوات المسلحة، فأمر بإيقاف التوسع قائلًا: “همّ وصلوا الجيزة خلاص بسنترال رمسيس… قلت: كفاية الجيزة وزحلِقهم بهدوء كده، وفعلاً زحلَقناهم”.
وظلت تلك الخطط مجمدة لسنوات، لكن الواقع ظل كما هو. سنترال رمسيس ظل مركز التحكم الأكبر، دون توزيع حقيقي جغرافي للأحمال أو وجود مراكز بديلة متوازية بالقوة ذاتها. وفي صباح يوم الحريق، انكشف المستور. اندلعت النيران في أحد السيرفرات بالدور السابع. وكان من المفترض أن يحتويها نظام الإطفاء الآلي “F200″، المصمم خصيصًا لحرائق مراكز البيانات، من خلال خنق الأكسجين ومنع انتشار اللهب في البيئة المحيطة.
لكن الحريق تمدد بسرعة غير متوقعة، وانتقل من السيرفر إلى قاعات مجاورة ثم إلى الأدوار السفلية، عبر المواسير التي تضم كابلات الداتا والفايبر. خلال ساعات قليلة، شُلّت قطاعات حيوية: توقفت البنوك، تعطلت ماكينات الصراف، سقطت تطبيقات الدفع الإلكتروني، تأثرت خدمات الإنترنت والمكالمات، وتوقف الحجز الإلكتروني في القطارات والطيران، بل وأصيبت المستشفيات بحالة ارتباك لعدم قدرتها على الوصول إلى البيانات الرقمية للمرضى.
في تلك اللحظات، شعر المصريون بأن البلاد أُصيبت بالشلل. بدا المشهد كأنه انهيار شامل، لمجرد أن نقطة مركزية واحدة خرجت عن الخدمة. ومع مرور الوقت، بدأت الحقائق تتكشف. في جلسة طارئة داخل البرلمان، عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة تداعيات الحادث، وبحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت والمستشار محمود فوزي، أوضح المهندس محمد نصر، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن الحريق بدأ في سيرفر بالدور السابع، وأن انتقاله تم عبر مواسير تحتوي على كابلات حساسة.
هذا التفسير يثير قلقًا مشروعًا؛ فإما أن السيرفر كان معيبًا رغم خضوعه لمواصفات عالمية دقيقة، أو أن هناك خللًا في التوصيلات الكهربائية المغذية له، مما قد يشير إلى ضعف جودة الخامات أو قصور في مفاتيح التحكم، التي كان من المفترض أن تفصل التيار فورًا. كما لا يمكن استبعاد فشل نظام الإطفاء الذاتي، سواء بسبب خلل في حساسات التشغيل أو ضعف في كفاءة الغاز المستخدم. الأخطر من ذلك أن انتقال الحريق عبر المواسير، يُفترض أنه مستحيل تقنيًا إذا كانت المواسير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، لأنها في الأصل يجب أن تكون غير قابلة للاشتعال وتطفئ ذاتيًا. ما حدث يشير إلى احتمال كبير بوجود مواد غير مطابقة أو تنفيذ مخالف لما ورد في دفاتر التعاقدات.
يجب إجراء مراجعة فورية لكل ملفات التوريد والتنفيذ، ومطابقتها على أرض الواقع، إلى جانب فحص شامل لأنظمة التأمين والحماية الذاتية، ليس فقط في سنترال رمسيس، بل في كل المنشآت الرقمية التابعة للدولة. فمثل هذا الحادث يمكن أن يتكرر في أي وقت، إن لم تكن هناك خطة قومية شاملة لحماية البنية التحتية الرقمية، تسبق الحدث لا تلحق به.
ورغم أن تأثير الحريق كان جزئيًا واستُعيدت الخدمات تدريجيًا خلال ساعات، إلا أن المشهد كان كافيًا لتذكيرنا بأننا نسير على “سلك بدون عزل”. لم يعد من المقبول أن تعتمد دولة بحجم مصر على مركز رقمي واحد في قلب العاصمة، بينما بالإمكان إنشاء مراكز موازية متكاملة في الإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان، وربطها بشبكة أقمار صناعية مستقلة، وتفعيل خطط طوارئ مرنة قادرة على توزيع الأحمال عند الطوارئ دون تأخير.
إن ما حدث ليس مجرد حريق، بل اختبار حقيقي لقدرتنا على حماية أمننا الرقمي. الكارثة لم تكن فقط في احتراق السيرفرات، بل في احتراق الثقة، وفي تهاوي فلسفة الإدارة، والتقاعس عن تنفيذ مراجعات دورية في مراكز تمس حياة ملايين المواطنين. رحم الله شهداء الوطن من أبطال الدفاع المدني الذين واجهوا النيران بشجاعة، بينما كنا نواجه جميعًا نيران الإهمال الإداري والتقني.
لقد آن الأوان أن نعيد ترتيب أوراقنا ونفهم أن البنية التحتية الرقمية اليوم أصبحت ركيزة من ركائز الأمن القومي، مثل المطارات ومحطات الكهرباء والسد العالي. كل من يُهملها، أو يديرها بغير كفاءة، لا يقل خطرًا عمّن يعبث بأمن الدولة عن عمد. والمناصب ليست أوسمة، بل أمانات. وإن لم يكن هناك حساب في الدنيا، فإن يوم الحساب في الآخرة لن يُؤجل.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.